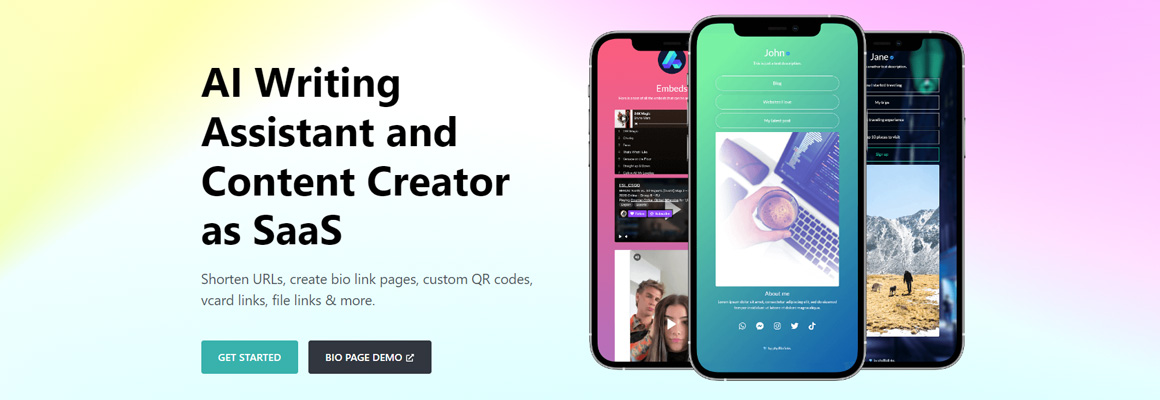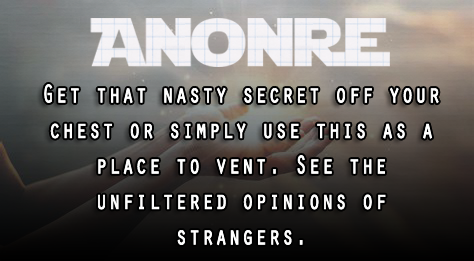تحل ذكرى ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش (1941-2008)، في 13 من مارس/آذار كل عام، في حين يواصل الراحل حضوره في الغياب منذ رحيله في التاسع من أغسطس/آب 2008، إذ يحضر في كل حين من خلال شعره الخالد الذي ما زال يقرأ ويُستشهد به للتعبير عن حياة الشعب والإنسان الفلسطيني، وعن معاناته التراجيدية التي نشأت بسبب تسلط الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والإنسان.
ربط درويش ميلاده وحياته بالوجود الفلسطيني، وتوقّف في كثير من قصائده عند آذار شهر الميلاد وشهر الأرض، ففي قصيدته الشهيرة (الأرض) دمج بين سيرته الذاتية وسيرة فلسطين منذ وقوعها تحت الانتداب الإنجليزي، ثم ما تبع ذلك عام 1948 فيما يقع ضمن مسمى النكبة في التاريخ الفلسطيني الحديث:
وفي شهر آذار، قبل ثلاثين عاماً وخمس حروب،
وُلدتُ على كومة من حشيش القبور المضيء.
أبي كان في قبضة الإنجليز. وأمي تربّي جديلتها
وامتدادي على العشب. كنتُ أُحبُّ “جراح
الحبيب” و أجمعها في جيوبي، فتذبلُ عند الظهيرة،
مَرّ الرصاصُ على قمري الليلكيِّ فلم ينكسرْ،
غير أنّ الزمان يَمرّ على قَمَري الليلكيِّ فيسقطُ سهواً…
وفي شهر آذار نمتدُّ في الأرضِ
في شهر آذار تنتشرُ الأرضُ فينا
مواعيدَ غامضةً
واحتفالاً بسيطاً
ونكتشف البحرَ تحت النوافذ
والقمرَ الليلكيَّ على السرو
في شهر آذار ندخلُ أوّل سجنٍ وندخلُ أوّل حُبٍّ
وتنهمرُ الذكرياتُ على قريةً في السياج
وُلدنا هناك ولم نتجاوز ظلال السفرجلِ
كيف تفرّين من سُبُلي يا ظلال السفرجل؟
في شهر آذار ندخلُ أوّل حُبٍّ
وندخلُ أوّل سجنٍ
وتنبلجُ الذكرياتُ عشاءً من اللغة العربية
ومن الناحية الشعرية تعد تجربة الشاعر الراحل محمود درويش تجربة كبرى في سياق تطور الشعر العربي بأسره، وقد امتد عطاؤه نحو نصف قرن من الشعر، ذلك أنه بدأ مبكرا، ونشر ديوانه الأول “عصافير بلا أجنحة” متعجلا الإعلان عن نفسه عام 1960 قبل أن تنضج هذه التجربة، ولذلك حذف الشاعر هذا الديوان من سيرته لأسباب فنية.
ولكنه مع ذلك ديوان ذو دلالة على التوجه القوي إلى الشعر والإيمان بقيمته، كما أن قصائده المبكرة تكشف دون تورية عن قراءاته وعن موارده المبكرة.
وقد جاء في مقدمته قول الشاعر الشاب آنذاك: “هذه القصائد تقدّس الحرية، وتقبّل الشهداء، وتغنّي على شباك حبيبتي، وتبكي مع شريد ضائع…”. ويكتب عن جملة العنوان: “وعصافير بلا أجنحة خلقت لتطير وتحلق..وتدوّخ اللحظات في تحليقها.. شاء لها القدر أن تقص أجنحتها وتنزف دمها على شوك الألم والحرمان هدرا وبلا نهاية.. لهذه العصافير أغني وأتألم وأثور، ولأجلها أصرخ في وجه الشمس كي تحيك من خيوط أشعتها ريشا لها لتنطلق غدا من جديد. ولغد هذه العصافير أقدم قصائدي”. (محمود درويش، حيفا، 1960).
وعندما نقرأ درويش وندقق في مسيرته، نشعر أنه ولد ليكون شاعرا، بموهبة فطرية لا حدود لها، ونزداد تقديرا لموهبته عندما نتبين أنه لا ينتمي إلى أسرة أدبية، ولا إلى محيط أسري فيه شعراء وكتّاب، فوالداه فلاحان بسيطان، ولاجئان في وطنهما، من عموم الشعب الفلسطيني، لا ينتميان للنخبة الفلسطينية قبل النكبة.
وقد توقف تعليمه الرسمي عند حدود المرحلة الثانوية، وتفرغ بعدها للشعر وللعمل المبكر في الصحافة والسياسة، لكنه حقق باجتهاده وعصاميته ما لا تستطيع المدارس والجامعات منحه، وهو ما يتمثل في شعره بصفة أولى، وفي سائر كتاباته وإسهاماته الثقافية على وجه العموم. ومعنى ذلك أنه علّم نفسه بنفسه معتمدا على ضرب من التربية الجمالية والسياسية الخاصة، حَريّة بأن تُدرس وأن تقرأ ضمن مسيرته الطويلة.
وربط ذلك كله بتطور شعره وبمراحله التي اجتازها بموهبة فائقة، صقلتها الثقافة والصنعة الواعية، واحترام الشعر والوعي بمثيراته، ومطالبه الفنية والإيقاعية واللغوية، في إطار من المعرفة الدقيقة بتاريخ الشعر العربي والعالمي، قديما وحديثا. وانتمى درويش إلى الشعر وإلى فلسطين معا انتماء أصيلا لا يعرف التلعثم أو التردد، وبلغ مستوى رفيعا من الثقافة والمعرفة على مختلف الأصعدة التي عرف أيضا كيف يوظفها في شعره ونثره.
ورغم انغماس درويش في الحركة الوطنية والسياسية الفلسطينية طوال عمره، داخل الوطن المحتل، وفي مرحلة الخروج والمنفى، فإنه ظلّ محافظًا على أصالة شعره وعلى تجدّده، وتنبّه إلى حصار الهمّ السياسي وخطر الوظيفة الوطنية التي ألقيت على شعره، فبذل جهدًا غير خفيّ لتحقيق التوازن بين الوظيفة الجمالية ومتطلبات اللحظة السياسية والوطنية، وعبّر شعره تعبيرًا عميقًا عن مشاغل الهويّة الفلسطينية وإشكالاتها، في ظل التهديد الذي تعرّضت له، وغدا أداة من أدوات المقاومة ضدّ المحو وضدّ العدوان على وجود الإنسان وعلى لغته.
جمالية الشعر والنضال
قَبِل درويش التحدّي وناء أحيانًا تحت ثقله، كيف تكون شاعرًا متميزًا بمعايير الجمال والشعر واللغة، وفي الوقت نفسه تفي بمتطلبات قضيتك الوطنية؟ في مختلف مراحله بدءًا من الأرض المحتلة احتلّ هذا السؤال مركز وعيه، ومقالته أو صيحته المبكّرة المنشورة في مجلة الجديد (حيفا، 1969) بعنوان “أنقذونا من هذا الحبّ القاسي” خير دليل على ذلك، إذ أدانت الإطراء الزائد الذي استُقبل به شعر المقاومة، وطالبت النقد العربي بأن يتحرّر من وهم التمجيد والإطراء والعطف، وألا يتردّد في نقد الرداءة الفنية.
تميزت مسيرته بالتحولات والانتقالات والتطورات، فلم تكن لونا واحدا، من ناحية تجلياتها الشعرية، وبالتأكيد ظل الشاعر أثناءها يتطور ويتغير، وهذا هو الأمر الطبيعي، وغير الطبيعي أن يظل على هيئة واحدة جامدة متكررة، فيدخل في التنميط والاعتياد. وهو يعي هذه التحولات ويراها ولادات متجددة لتجربته الممتدة: “قليلون هم الشعراء الذين يولدون شعريا دفعة واحدة، أما أنا فقد ولدت تدريجيا وعلى دفعات متباعدة وما زلت أتعلم المشي العسير على الطريق الطويل إلى قصيدتي التي لم أكتبها بعد”.
وهو يشير في موطن آخر إلى حرصه على مراجعة قصيدته وتنقيحها كأنه شاعر من شعراء الصنعة أو الحوليات: “أنا من أولئك الذين يكتبون النص مرتين، في المرة الأولى تقودني سليقتي الشعرية ولا وعيي، وفي المرة الثانية يقودهما إدراكي لمتطلبات بناء القصيدة وغالبا ما لا تشبه الكتابة الثانية صورة الكتابة الأولى، لا تشبهها أبدا”. فهو شاعر كبير بفنه وتفننه، وحرصه على التطور وعدم التوقف عند مرحلة أو قصيدة واحدة، وربما لهذا السبب لم يرد أن يحبسه الجمهور في قصائده الأولى، وأشهرها “بطاقة هوية” التي عرف بها أول ما اشتهر: “عرفت الناس عليّ، ولكن هذا لا يعني أن أبقى أو يبقى شعري أسيرَها”.
ودرويش شاعر واع منظّر يمتلك وعيا ناضجا بالقصيدة وبالتجربة الشعرية، تجد هذا الوعي في حواراته وفي كتاباته النثرية، مما يقفنا على حقيقة مهمة تربط الشعر بالوعي النقدي، وأن الشاعر المتمكن والجيد لا بد له من نظرية أو شبه نظرية تربط الجمالي بالفكري والسياسي.
ومن لمحاته النظرية التي تفسر بعض وعيه قوله: “أنا المسمى شاعرا فلسطينيا أو شاعر فلسطين مطالب مني ومن شرطي التاريخي بتثبيت المكان في اللغة، وبحماية واقعي من الأسطورة وبامتلاكهما معا لأكون جزءا من التاريخ وشاهدا على ما فعله التاريخ بي في آن واحد، لذا يتطلب حقي في الغد تمردا على الحاضر، ودفاعا عن شرعية وجودي في الماضي الذي زج به في المناظرة، حيث تصبح القصيدة دليلا على وجود أو عدم، أما سكان القصيدة فلا يكترث بهم مؤرخو الشعر”.
طوّع درويش الشعر بمهارة نادرة، مستعملا حزمة واسعة من الأدوات والأساليب والمهارات في التعامل مع اللغة والإيقاع والصورة، بروح شعرية معاصرة تدمج الغنائي بالملحمي والسردي، وتصل الشعر بالنثر، وتربط المعاني المجردة بتفاصيل الحياة والواقع، وتربط التراث العربي بالثقافة العالمية، في سبيل التعبير عن دقائق التجربة الذاتية والعامة، أي تجربة الشاعر وتجربة الجماعة الفلسطينية التي ينتمي إليها. ورغم جماهيريته الواسعة فإنه لم يستسلم للجمهور ولمطالبه، بل كان ينقاد إلى ما يتطلبه الوعي الجمالي وتدابير الشعر والشاعرية.
ولقد أثمرت مسيرته الإبداعية عن نحو 25 مجموعة شعرية، و10 مؤلفات نثرية، وعدد كبير من الحوارات الأدبية والفكرية والسياسية. وهي مفتوحة على القراءة والتأويل والتفسير والمتعة، أي أن كل قارئ محب للشعر قد يجد فيها شيئا يفيده أو يمتعه.
وحسبنا في هذا المقام الموجز أن نشير إلى بعض ما يحسن النهوض به لخدمة هذه التجربة الكبيرة:
أولا: لم يُنشر جميع شعره في دواوين أو كتب، ذلك لأنه كان شديد المراجعة والدقة في بناء دواوينه ومجموعاته، ولذلك فله أشعار منشورة في الصحف والدوريات داخل فلسطين وخارجها ولم تشتمل عليه أعماله الشعرية المنشورة، لأسباب وملابسات متعددة. اليوم لا بد من جمع كل أشعاره بوصفها جزءا من “تركة” الشاعر الثمينة، وتصنيفها وحفظها ونشرها بما يليق بمكانته وشاعريته.
ثانيا: هناك أيضا “تراث” نثري لمحمود درويش، لم ينشر في كتب إلا القليل منه، أي أن “تركته” الكتابية أوسع بكثير مما نشر في كتب يعرفها الناس حتى اليوم، فلقد داوم على الكتابة النثرية بسبب عمله المباشر في الصحافة والثقافة والسياسة، وله مئات المقالات والكتابات والحوارات التي لم تُجمع في كتاب. والشعوب الحية تعنى بكل تراث شعرائها، بما في ذلك ما لا يعده الشاعر نفسه مهما، فهذا التراث ضرب من “التاريخ” وهو مهم بكل تفاصيله، يترك تقرير أمره والإفادة منه بعد جمعه وتصنيفه للدارسين والمهتمين والقراء، مما يقتضي جمع مقالاته من مواردها ومظانها المتفرقة، ومقارنتها بما جمع في كتب ونشر ما لم ينشر مؤرخا ومصنفا بدقة ووضوح.
ثالثا: شعر درويش محتاج لا إلى دراسات نقدية فحسب، وإنما إلى توسيع الدراسات الدرويشية لتشمل ألوانا من الموسوعات والمعاجم والكتب الشارحة، التي توضحه وتضعه في سياقه التاريخي، وتفسّر بعض غوامضه من ناحية الإحالات المكانية (معجم الأماكن الدرويشية)، وكذلك في شعره مئات الشخصيات الواقعية والتاريخية والرمزية المحتاجة إلى إيضاح يلقي أضواء كاشفة عن شعره، فنحن محتاجون إلى (معجم الشخصيات الدرويشية) على سبيل المثال، على شاكلة ما قام به دارس فلسطيني نابه هو د.حسين حمزة عندما وضع “معجم الموتيفات المركزية في شعر محمود درويش” فكان عملا كبيرا يدل القارئ على جانب من العناصر المتكررة مع مواضع ورودها في أعماله ليمكن مقارنتها ومقاربتها في الدراسات أو حتى القراءات المدققة في هذا الشعر الثري الغني.
وسأذكر مثالا واحدا على ما قد تضيفه مثل هذه التعريفات من فائدة: قصيدة “جندي يحلم بالزنابق البيضاء” قصيدة مهمة وإشكالية في مسيرة، تتعلق بنظرته إلى الآخر، وتستضيف جنديا إسرائيليا غير مسمى في القصيدة، لكن بعد عدة عقود يكشف الجندي السابق عن نفسه فإذا به المؤرخ “شلومو ساند” أحد المؤرخين الجدد مؤلف الكتاب المعروف “اختراع الشعب اليهودي” وهو يشرح صلة القصيدة به ومعرفته بدرويش شرحا وافيا في توطئة كتابه المترجم إلى العربية.
رابعا: لم يكتب درويش سيرته الشعرية، وإنما استبدل بها قصائد وكتابات نثرية ذات طابع سيري، وما زالت سيرته الكاملة المفصلة غير مكتوبة، وكتابتها ليست أمرا هينا، ولكنها ليست صعبة في ضوء تطور أساليب كتابة السيرة الغيرية، ووجود مصادر كافية لها. وضع مثل هذه السيرة المرجعية إضافة نوعية إلى ما يخدم هذه التجربة، فالشعوب الحية جميعها تضع سيرا لا سيرة واحدة لمبدعيها.
خامسا: تشجيع المتخصصين بالأدب المقارن والآداب الأجنبية على إجراء دراسات مقارنة، تضع درويش في سياق الشعر العالمي، خصوصا في ضوء تجارب بعض الشعراء الذين أعجب بشعرهم، من إليوت ولوركا وناظم حكمت وكافافي وريتسوس وصولا إلى أكتافيو باث وشيموس هني وديريك والكوت وغينسبرغ وغيرهم.
سادسا: ديوان درويش الأخير “لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي” الذي صدر عام 2009، يثير الحنق والألم، وهو في أقل تقدير محتاج إلى تحقيق علمي ونشر جديد على أسس صحيحة، فالعمل المنشور فيه أخطاء لا يصح تركها والسكوت عليها، فدرويش ملك لشعب بل لأمة بأسرها، ولا يقبل أن يصدر ديوانه بأخطائه العروضية والإملائية والنحوية والطباعية، وهو المعروف عنه تحري الدقة والصحة قبل الجمال والبلاغة.
ببلوغرافيا محمود درويش
دواوين شعرية:
“عصافير بلا أجنحة”، (1960)، حيفا. “أوراق الزيتون”، (1964)، حيفا. “عاشق من فلسطين”، (1966)، الناصرة. “آخر الليل”، (1967)، عكا. “العصافير تموت في الجليل”، (1969)، بيروت. “حبيبتي تنهض من نومها”، (1970)، بيروت. “أحبك أو لا أحبك”، (1972)، بيروت. “محاولة رقم 7″، (1973)، بيروت. “تلك صورتها وهذا انتحار العاشق”، (1975)، بيروت. “أعراس”، (1977)، بيروت. “مديح الظل العالي”، (1983)، بيروت. “حصار لمدائح البحر”، (1984)، بيروت. “هي أغنية.. هي أغنية”، (1986)، بيروت. “ورد أقلّ”، (1986)، بيروت. “أرى ما أريد”، (1990)، بيروت. “أحد عشر كوكبا”، (1992)، بيروت. “لماذا تركت الحصان وحيدا؟”، (1995)، بيروت. “سرير الغريبة”، (1999)، بيروت. “جدارية”، (2000)، بيروت. “حالة حصار”، (2002)، بيروت. “لا تعتذر عما فعلت”، (2004)، بيروت. “كزهر اللوز أو أبعد”، (2005)، بيروت. “أثر الفراشة”، (2008)، بيروت. “لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي”، (2009). “خطب الدكتاتور الموزونة”، (2013)، حيفا. (نشر في مجلة اليوم السابع، وفي مجلة شعر المصرية، ولم ينشره درويش في كتاب أثناء حياته).
الأعمال النثرية:
“شيء عن الوطن”، (1971). “يوميات الحزن العادي”، (1973). “وداعا أيتها الحرب وداعا أيها السلام”، (1974). “ذاكرة للنسيان”، (1987). “في وصف حالتنا”، (1987). “في انتظار البرابرة”، (1987). “الرسائل (محمود درويش وسميح القاسم)”، (1999). “في حضرة الغياب”، (2006). “حيرة العائد”، (2007).
![]()