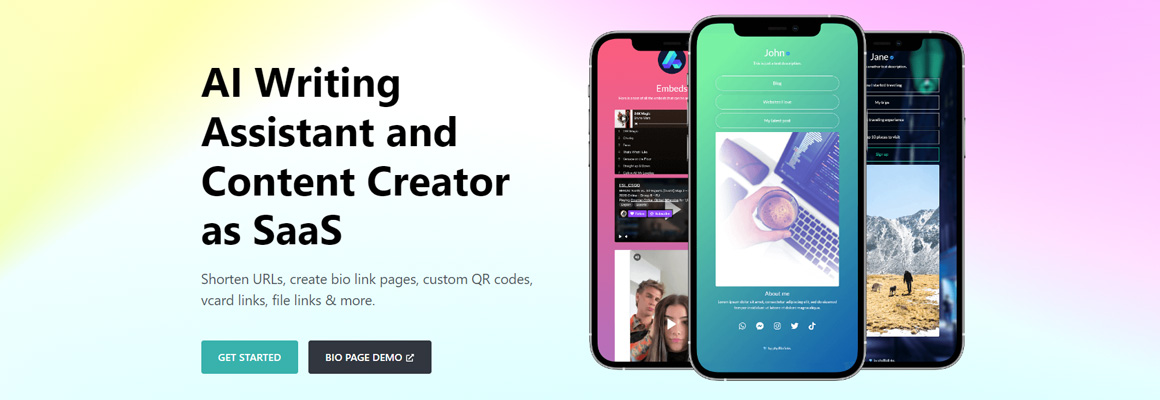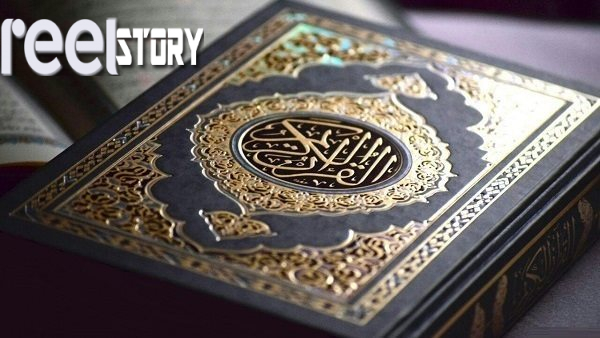ترجمة: علاء الدين أبو زينة
ويليام ماكاسكيل* – (فورين أفيرز) عدد أيلول (سبتمبر)/ تشرين الأول (أكتوبر) 2022
نحن الآن في بداية التاريخ. مقابل كل شخص على قيد الحياة اليوم، عاش عشرة أشخاص وماتوا في الماضي. ولكن، إذا نجا البشر ليعيشوا بقدر ما تعيش أنواع الثدييات في المتوسط، فإنه مقابل كل شخص على قيد الحياة اليوم، سيعيش ألف شخص في المستقبل. وسنكون نحن “القدماء”. وبمقياس الحياة البشرية النموذجية، فإن البشرية اليوم بالكاد طفل رضيع يكافح من أجل المشي.
على الرغم من أن مستقبل جنسنا البشري قد يكون طويلاً، إلا أنه ربما يكون عابرًا فحسب بالمقدار نفسه. ومن بين التطورات العديدة التي حدثت منذ صدور العدد الأول من هذه المجلة قبل قرن من الزمان، كان التطور الأكثر أهمية هو قدرة البشرية على إنهاء نفسها. من تغير المناخ إلى الحرب النووية، والأوبئة المهندَسة، والذكاء الاصطناعي غير المنضبط، وغيرها من التقنيات المدمرة التي لا يمكن التنبؤ بها بعد، يتآمر عدد مقلق من المخاطر للتهديد بنهاية البشرية.
قبل ما يزيد قليلاً على 30 عامًا، مع اقتراب الحرب الباردة من نهايتها، رأى بعض المفكرين المستقبل وهو يتكشف بطريقة أكثر هدوءاً بما لا يُقاس. كان خطر حلول نهاية العالم، الذي طاف بالغ الوضوح في مخيلة حقبة الحرب الباردة، قد شرع في الانحسار. بدا أن نهاية الشيوعية بعد بضعة عقود من هزيمة الفاشية خلال الحرب العالمية الثانية قد حسمت الجدالات الأيديولوجية الرئيسية. سوف تنتشر الرأسمالية والديمقراطية ويسودان بلا هوادة. وقسَم المنظر السياسي، فرانسيس فوكوياما، العالم إلى مجتمعات “ما بعد تاريخية” و”تاريخية”. ربما تستمر الحرب في أجزاء معينة من العالم في شكل صراعات عرقية وطائفية، على سبيل المثال. لكن الحروب واسعة النطاق ستصبح شيئًا من الماضي مع انضمام المزيد والمزيد من الدول إلى أمثال فرنسا واليابان والولايات المتحدة على الجانب الآخر من التاريخ. وعرَض المستقبل طيفاً ضيقاً من الاحتمالات السياسية، حيث وعد بالسلام النسبي، والازدهار، والحريات الفردية متزايدة الاتساع بلا توقف.
لكن احتمال مستقبل أبدي للبشرية أخلى مكانه لرؤى للا-مستقبل على الإطلاق. ما تزال الأيديولوجيا خط صدع في الجغرافيا السياسية؛ وعولمة السوق آخذة في التفتت؛ وأصبح الصراع بين القوى العظمى أكثر احتمالاً باطراد. لكن التهديدات للمستقبل تظل أكبر من ذلك، مع احتمال القضاء على الجنس البشري كله. وفي مواجهة هذا الذهاب المحتمل إلى ثقب النسيان، يغلب أن يكون نطاق المناقشات في السياسة والسياسي أعرض نطاقاً في السنوات المقبلة مما كانت عليه منذ عقود. ما تزال النزاعات الأيديولوجية الكبرى بعيدة كل البعد عن التسوية. وفي الحقيقة، من المرجح أن نواجه أسئلة أكبر، وأن نضطر إلى النظر في مقترحات أكثر جذرية تعكس التحديات التي تفرضها التحولات والمخاطر المقبلة. وينبغي أن تتوسع آفاقنا لا أن تتقلص.
لعل الأهم من بين تلك التحديات هو كيف تدير البشرية المخاطر التي تسفر عنها عبقريتها الخاصة. يمكن أن يؤدي التقدم في الأسلحة والبيولوجيا والحوسبة إلى نهاية الأنواع، إما من خلال سوء الاستخدام المتعمد أو حادث عرَضي واسع النطاق. وتواجه المجتمعات مخاطر يمكن أن يشل حجمها الهائل أي عمل منسق. ولكن يمكن للحكومات، بل ويجب عليها، أن تتخذ خطوات ذات معنى اليوم لضمان بقاء نوعنا البشري من دون التخلي عن منافع التقدم التقني. في الحقيقة، سوف يحتاج العالم إلى الابتكار للتغلب على العديد من المخاطر الكارثية التي يواجهها فعلياً -تحتاج البشرية إلى أن تكون قادرة على توليد الطاقة النظيفة وتخزينها، والكشف عن الأمراض الجديدة عندما يكون ما يزال من الممكن احتواؤها، والحفاظ على السلام بين القوى العظمى من دون الاعتماد على توازن هش على أساس إمكانية الدمار المتبادل المؤكد الذي تمكّنه الأسلحة النووية.
بعيدًا عن أن يكون مكان استراحة آمنا، يشكل الراهن التقني والمؤسسي مأزقاً محفوفاً بالمخاطر تحتاج المجتمعات إلى الهروب منه. ولوضع الأساس لهذا الهروب، يجب على الحكومات أن تصبح أكثر وعيًا بالمخاطر التي تواجهها وأن تطور جهازًا مؤسسيًا قويًا لإدارتها. ويشمل ذلك تضمين اهتمام بأسوأ السيناريوهات في المجالات ذات الصلة من صنع السياسات وتبني فكرة تعرف باسم “التطور التقني التفاضلي” -كبح جماح العمل الذي يمكن أن يفرز نتائج خطيرة محتملة، مثل البحوث البيولوجية القابلة للتسليح، مع تمويل وتسريع تلك التقنيات التي يكون من شأنها أن تساعد على تقليل المخاطر، مثل مراقبة مياه الصرف الصحي للكشف عن مسببات الأمراض.
سوف يكون التحول الأكبر المطلوب تحولاً في المنظور. لقد نظر فوكوياما إلى المستقبل بطريقة حزينة بعض الشيء، ورأى مدى رمادياً غير دراماتيكي -لوحة حية للتكنوقراط. وكتب في العام 1989: “سوف تكون نهاية التاريخ وقتاً حزيناً للغاية”، يجري فيه استبدال “الجرأة والشجاعة والخيال والمثالية، بالحسابات الاقتصادية، ومحاولات الحل التي لا تنتهي للمشاكل التقنية، والمخاوف البيئية، وتلبية المطالب المعقدة والمتطورة للمستهلكين”. ولكن، في هذه البداية للتاريخ؛ هذا المنعطف الحرج من قصة الإنسانية، سيتطلب الأمر التحلي بالجرأة والخيال لمواجهة التحديات المختلفة المقبلة. وعلى النقيض مما توقعه فوكوياما، فإن الأفق السياسي لم يضق إلى حد يصعب حله. ما تزال التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الهائلة ممكنة -وضرورية. وإذا تصرفنا بحكمة، فإن القرن المقبل سيتحدد بالاعتراف بما ندين به للمستقبل، وسوف ينظر أحفاد أحفادنا إلينا بامتنان وفخر. أما إذا أخفقنا، فإنهم قد لا يرون النور أبدًا.
أولئك الذين لم يأتوا بعد
يشير السجل الأحفوري إلى أن أنواع الثدييات تدوم في المتوسط نحو مليون عام. وبهذا المقياس، ستكون أمامنا نحو 700.000 سنة. وخلال هذا الوقت، حتى لو ظلت البشرية مقيدة بكوكب الأرض بمقدار عُشر سكان العالم الحاليين، فإن عشرة تريليونات شخص سيولدون في المستقبل.
كما أن نوعنا ليس من الثدييات العادية المتوسطة، وقد يكون البشر قادرين على الصمود والبقاء أكثر من أقاربهم. وإذا بقينا على قيد الحياة إلى أن تحرق الشمس المتوسعة الأرض، فإن البشرية ستستمر لمئات الملايين من السنين. وسوف يفصلنا زمن عن آخر أحفادنا أطول من الذي يفصلنا عن الديناصورات الأولى. وإذا استوطنّا في يوم من الأيام الفضاء -وهو احتمال يمكن تصوره بالكامل على نطاق آلاف السنين- فإن الحياة الذكية الناشئة عن الأرض يمكن أن تستمر حتى تحترق آخر النجوم بعد عشرات التريليونات من السنين.
بعيدًا عن كونه تمرينًا لقضاء الوقت في التلاعب بأعداد لا يمكن سبر غورها، فإن تقدير الحجم المحتمل لمستقبل البشرية أمر حيوي لفهم ما هو على المحك. يمكن أن تؤثر أفعالنا اليوم على ما إذا كان يمكن أن يعيش تريليونات من أحفادنا وكيف يمكن أن يعيشوا -ما كانوا سيعيشون مع الفقر أو الوفرة، أو الحرب أو السلام، أو العبودية أو الحرية- مما يضع مسؤولية مفرطة على أكتاف الراهن. وتتضح العواقب العميقة لمثل هذا التحول في المنظور من خلال تجربة مذهلة أجريت في بلدة “ياهابا” اليابانية الصغيرة. قبل مناقشة سياسة البلدية، طلُب من نصف المشاركين ارتداء أردية احتفالية وتخيُّل أنهم آتون من المستقبل، ويمثلون مصالح أحفاد المواطنين الحاليين. ولم يلاحظ الباحثون “تناقضاً صارخاً في أساليب المداولات والأولويات بين المجموعات فحسب”، بل كان الاهتمام بالأجيال المقبلة مُعدياً -من بين التدابير التي أمكن تحقيق توافق في الآراء بشأنها، تم اقتراح أكثر من نصفها من قبل الأحفاد المتخيلين.
قصة الإنسانية قد تنتهي قبل أن تبدأ حقًا
يكشف التفكير طويل المدى عن مقدار ما يزال يمكن للمجتمعات أن تحققه. قبل وقت لا يزيد على 500 عام، كان من غير القابل للتصور أن تتضاعف الدخول ذات يوم كل بضعة أجيال، وأن يعيش أغلب الناس لرؤية أحفادهم وهم يكبرون، وأن تكون الدول الرائدة في العالم مجتمعات علمانية يجري اختيار قادتها في انتخابات حرة. والآن قد لا تستمر البلدان التي تبدو دائمة جدًا لمواطنيها لأكثر من بضعة قرون. ولم يتكرر أي من أنماط التنظيم الاجتماعي المختلفة في العالم في التاريخ بشكل كامل. وسوف يحجب التركيز قصير الأجل على الأيام أو الأشهر أو السنوات إمكانية إحداث تغيير أساسي طويل الأجل.
تسلط حقيقة أن البشرية ما تزال في مهدها فحسب الضوء على أي مأساة هي التي قد يكونها موتها المفاجئ في غير أوانها. ثمة الكثير من الحياة المتبقية لتعيشها البشرية، لكنّ انتباهنا ينتقل، في شبابنا، بسرعة من شيء إلى آخر، ونسير متعثرين من دون أن ندرك أن بعض أفعالنا تعرضنا لخطر شديد. وتزداد قوانا يومًا بعد يوم، لكن وعينا الذاتي وحكمتنا يتخلفان في الوراء. وقد تنتهي قصتنا قبل أن تبدأ حقًا.
كيف يمكن أن ننهي التاريخ؟
على النقيض من “نهاية التاريخ” التي أعلنها فوكوياما، ركز مراقبون آخرون للشؤون الدولية على المعنى الحرفي للعبارة: احتمال هلاك البشرية جملة وتفصيلاً. وكانت مثل هذه الآراء سائدة بشكل خاص في فجر حقبة الحرب الباردة، بعد فترة وجيزة من تحقيق العلماء النوويين قفزة هائلة في الإمكانيات التدميرية للبشرية. وكما قال رجل الدولة البريطاني ونستون تشرشل في العام 1946 بحماس مميز: “قد يعود العصر الحجري على أجنحة العلم المتلألئة، وما قد يمطر البشرية الآن ببركات مادية لا حصر لها، ربما يجلب عليها حتى دمارها الكامل”. وبعد بضع سنوات، ردد الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور صدى هذه المخاوف خلال خطاب تنصيبه الأول، الذي حذر فيه من أن “العلم يبدو مستعدًا لمنحنا، كهدية أخيرة، القدرة على محو الحياة البشرية من هذا الكوكب”.
إن التاريخ البشري مليء بالكوارث، من أهوال ”الموت الأسود” إلى أهوال العبودية والاستعمار. ولكن، باستثناء بعض الأحداث الطبيعية غير محتملة الحدوث إلى حد كبير، مثل ثوران البراكين الفائقة أو الشهب التي تتحطم على الكوكب، لم تكن هناك آليات معقولة يمكن للبشرية ككل أن تهلك من خلالها. في كتابه “الهاوية” The Precipice، قدر فيلسوف أكسفورد، توبي أورد، أنه حتى مع قبول جميع الافتراضات الأكثر تشاؤمًا، فإن المخاطر المتراكمة لانقراض يحدث بشكل طبيعي تظل توفر للبشرية عمرًا متوقعًا لا يقل عن 100 ألف عام.
ظهرت مخاوف جدية بشأن “الكارثة الوجودية” -التي عرّفها أورد بأنها التدمير الدائم لإمكانات البشرية- بشكل رئيسي في النصف الثاني من القرن العشرين، يداً بيد مع تسارع التقدم التقني. وكتب اللورد مارتن ريس، الرئيس السابق لـ”الجمعية الملكية”، في العام 2003 أن احتمالات بقاء البشرية على قيد الحياة في هذا القرن “ليست أفضل من 50-50”. وقدر أورد احتمال أن تمحو البشرية نفسها أو تُخرج مسار الحضارة عن سكته بشكل دائم عند واحد من ستة في غضون الأعوام المائة المقبلة. وإذا كان أي منهما على حق، فإن الطريقة الأكثر ترجيحًا التي يمكن أن يموت بها أميركي مولود اليوم وهو شاب هي حدوث كارثة منهية للحضارة.
حتى وقت قريب، كانت هناك طرق قليلة يمكن أن تهلك بها البشرية جمعاء
تعرض الأسلحة النووية العديد من الخصائص الحاسمة التي يمكن أن تمتلكها التهديدات التكنولوجية المستقبلية أيضاً. عندما اختُرعت في منتصف القرن العشرين، أحدَثت قفزة مفاجئة في القدرات التدميرية: كانت القنبلة الذرية أقوى بآلاف المرات من المتفجرات ما قبل النووية؛ وسمحت القنابل الهيدروجينية بإنتاج متفجرات أقوى بآلاف المرات مرة أخرى. وبالمقارنة مع وتيرة الزيادات في الطاقة التدميرية في العصر ما قبل النووي، فقد حدث 10.000 عام من التقدم في غضون بضعة عقود فقط.
كان من الصعب توقع هذه التطورات: فقد رفض الفيزيائي البارز، إرنست رذرفورد، فكرة الطاقة الذرية باعتبارها “هراء” في وقت متأخر نسبياً هو أواخر العام 1933، قبل عام واحد من حصول ليو زيلارد، وهو فيزيائي مشهور آخر، على براءة اختراع لفكرة مفاعل الانشطار النووي. وبمجرد وصول القنابل النووية، أصبح من الممكن إطلاق العنان للدمار إما عمدًا، كما حدث عندما دعا جنرالات الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة نووية أولى للصين خلال أزمة مضيق تايوان في العام 1958، أو عن طريق الخطأ، كما يتضح من السجل المروع للأخطاء في أنظمة الإنذار المبكر. بل إن الأسوأ من ذلك هو أن تدابير الدفاع ضد هجوم متعمد غالبًا ما جاءت على حساب زيادة خطر حدوث “هرمجدون” نووي عرَضي. ولنتأمل هنا، على سبيل المثال، نظام التأهب المحمول جوًا للولايات المتحدة: إنه قائم على مبدأ الإطلاق- عند- التحذير؛ أو نظام “اليد الميتة” السوفياتي، الذي ضمن أنه إذا تعرضت موسكو لهجوم نووي، فإنها ستشن تلقائيًا ردًا نوويًا شاملاً. ولم تغير نهاية الحرب الباردة هذه الحسابات المميتة تغييرًا جذريًا، وما تزال القوى النووية تضع التوازن بين السلامة واستعداد القوة في صميم سياساتها. وقد تفرض التقنيات المستقبلية مقايضات أكثر خطورة بين السلامة والأداء.
نهاية العالم قريباً
لكن الأسلحة النووية بعيدة كل البعد عن أن تكون المخاطر الوحيدة التي نواجهها. يمكن أن تكون العديد من التقنيات المستقبلية أكثر تدميرًا، أو أسهل من حيث إمكانية الحصول عليها لمجموعة أوسع من الجهات الفاعلة، أو تثير قدراً أكبر من المخاوف بشأن الاستخدام المزدوج، أو تتطلب عددًا أقل من الأخطاء للإيذان بانقراض جنسنا البشري -وبالتالي يكون ضبطها أصعب بكثير. وقد حدد تقرير حديث صدر عن “مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي” الذكاء الاصطناعي الجامح والأوبئة الهندسية وأسلحة تكنولوجيا النانو، إضافة إلى الحرب النووية، كمصادر لمخاطر وجودية- “التهديدات التي يمكن أن تضر بالحياة على نطاق عالمي”، و”تتحدى قدرتنا على تخيل وفهم نطاقها وحجمها المحتملين”.
خذ على سبيل المثال، الأوبئة المهندسة. كان التقدم المحرز في مجال التكنولوجيا الحيوية سريعًا للغاية؛ حيث انخفضت التكاليف الرئيسية، مثل تكاليف تسلسل الجينات، بشكل مطرد التسارع. ويعِد المزيد من التقدم في هذا الحقل بالعديد من الفوائد، مثل العلاجات الجينية للأمراض المستعصية حتى الآن. لكن المخاوف المتعلقة بالاستخدام المزدوج تخيم على الأفق بقوة: من حيث المبدأ، يمكن استخدام بعض الأساليب المستخدمة في البحوث الطبية لتحديد أو إنشاء مسببات لأمراض أكثر قابلية للانتقال والفتك من أي شيء موجود في الطبيعة. ويمكن القيام بذلك كجزء من المشاريع العلمية المفتوحة -حيث يقوم العلماء أحياناً بتعديل مسببات الأمراض لمعرفة كيفية مكافحتها- أو بنوايا أقل نبلاً في برامج الأسلحة البيولوجية الإرهابية أو التي تديرها الدولة. (ليست مثل هذه البرامج شيئًا من الماضي: فقد خلص تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في العام 2021 إلى أن كلا من كوريا الشمالية وروسيا تحتفظان ببرنامج أسلحة بيولوجية هجومية). كما يمكن أيضاً إساءة استخدام الأبحاث المنشورة بنوايا خادمة للمجتمع من قبل الجهات الفاعلة السيئة، ربما بطرق لم يفكر فيها المؤلفون الأصليون أبدًا.
على عكس الأسلحة النووية، فإن البكتيريا والفيروسات تتكاثر ذاتياً. وكما أثبتت جائحة “كوفيد -19” بطريقة مأساوية، فإنه بمجرد أن يصيب عامل ممرض جديد إنسانًا واحدًا، قد لا تكون هناك طريقة لإعادة المارد إلى القمقم. وعلى الرغم من أن تسع دول فقط تمتلك أسلحة نووية -حيث تسيطر روسيا والولايات المتحدة على أكثر من 90 في المائة من جميع الرؤوس الحربية- إلا أن في العالم آلاف من المختبرات البيولوجية. ومن بين هذه، ثمة العشرات -المنتشرة في خمس قارات- التي تمتلك تراخيص للتجريب في أخطر مسببات الأمراض في العالم.
ولعل الأسوأ من ذلك كله حقيقة أن سجل السلامة في البحوث البيولوجية مقبض أكثر من سجل الأسلحة النووية. في العام 2007، تسرب مرض الحمى القلاعية، الذي ينتشر بسرعة في مجموعات الماشية ويمكن أن يسبب بسهولة خسارة مليارات الدولارات من الأضرار الاقتصادية، ليس مرة واحدة وإنما مرتين من المختبر البريطاني نفسه في غضون أسابيع، حتى بعد تدخل الحكومة. وأدت التسربات المختبرية فعلياً إلى التسبب بخسائر في الأرواح البشرية، كما حدث عندما هربت الجمرة الخبيثة المسلحة من مصنع مرتبط ببرنامج الأسلحة البيولوجية السوفياتي في سفيردلوفسك في العام 1979، مما أسفر عن مقتل العشرات من الناس. ولعل الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو أن الأدلة الجينية تشير إلى أن جائحة “الانفلونزا الروسية” التي حدثت في العام 1977 ربما نشأت في تجارب بشرية شملت سلالة إنفلونزا قديمة كانت قد انتشرت في الخمسينيات. وأدت الجائحة إلى وفاة نحو 700 ألف شخص.
في الإجمال، حدثت مئات الإصابات العرَضية في المختبرات الأميركية وحدها؛ مع وقوع إصابة واحدة لكل 250 شخصاً في السنة من العمل المختبري. وبما أن هناك العشرات من المختبرات عالية الحراسة في العالم، التي يعمل في كل منها العشرات، وربما المئات، من العلماء وغيرهم من العاملين، فإن هذا المعدل يرقى إلى عدد متضاعف من الإصابات العرضية سنويًا. ويجب على المجتمعات أن تخفض هذا المعدل بدرجة كبيرة. وإذا بدأت هذه المرافق في أي وقت في العبث بمسببات الأمراض على مستوى الانقراض، فإن النهاية المبكرة للبشرية ستكون مسألة وقت فحسب. (يُتبع)
* ويليام ماكاسكيل William MacAskill: أستاذ مشارك في الفلسفة في جامعة أكسفورد وزميل باحث أول في “معهد الأولويات العالمية” Global Priorities Institute. وهو مؤلف الكتاب المقبل ”ما ندين به للمستقبل” What We Owe the Future.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Beginning of History: Surviving the Era of Catastrophic Risk
![]()